
من المؤسف أن يقع مثقف واسع الاطلاع ضحية آلية اقتطاع دعائي مبتذل، وأن تختزل جملة قيلت في سياق الاستشهاد إلى عبارة مبتورة توحي بتبن مباشر لمقولة لم تقل. ولا خلاف على أن هذا الأسلوب في صيد الاستفزاز صار جزءا من اقتصاد المشاهدات، وأن القنوات تعرف تماما أين تضع السكين، في بداية الجملة أو نهايتها. وقد بيّن وسام سعادة أكثر من مرة أن ما حدث جرى بغير علمه، وقد شكا ضعف المهنية والاحتراف لدى هذه القناة. والجملة التي أثارت جدلا هي اقتباس من ساطع الحصري، إذ اعتبر أن العصر الذهبي للعرب هو عصر الجاهلية، لكن القناة عند الإعلان عن الحلقة اقتطعت ذكر ساطع الحصري، فظهر وسام سعادة كأنه يقول رأيه.وبما أن الموضوع أثار جدلا، فربما تكون هذه مناسبة لشرح بعض المسائل المعروفة في مجال الدراسات الإسلامية، والتي قد لا تكون واضحة للقارئ غير المتخصص، وقد وردت ضمن النقاط التي أثيرت. الجاهلية كمفهوم إن التفكير في مفهوم الجاهلية ذاته أمر مشروع ومهم دون شك. فمن الممكن قراءة النص القرآني على أن الجاهلية ليست توصيفا زمنيا فحسب، بل حالة سلوكية وقيمية قد تتجاوز التحقيب التاريخي الضيق. والتفريق بين الجاهلية كمفهوم أخلاقي، والجاهلية كمرحلة تاريخية في شبه الجزيرة العربية، مسألة تستحق الدراسة الهادئة بعيدا عن التوظيف السياسي أو الشعاراتي. والبحث في هذا الباب يمكن أن يكون إضافة معرفية حقيقية. وفي التراث الإسلامي ما يوضح هذه الدلالة بجلاء، كما في الحديث المعروف حين عيّر الصحابي أبو ذر رجلا بأمه لأنها كانت أعجمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا السياق يبين أن المسألة ليست مسألة تحقيب زمني فقط، بل سلوك وقيم. طه حسين وحدود المنهج أما قضية الأديب العربي الكبير طه حسين فهي محطة مهمة في تاريخ الفكر العربي الحديث. كان منهجه قائما على الشك التاريخي في مصادر الرواية العربية المبكرة، وهو توجه تأثر فيه بجو نقدي شائع في دراسات ذلك الزمن. ورأى أن كثيرا مما نسب إلى العصر الجاهلي صيغ في عصور لاحقة لخدمة اعتبارات لغوية أو قبلية أو سياسية. غير أن الإشكال ظهر عندما انتقل هذا المنهج من التشكيك في نصوص أدبية إلى مساءلة البنية التاريخية التي تتصل، مباشرة أو غير مباشرة، ببعض الروايات الإيمانية. ففي بعض المواضع بدت قراءته وكأنها تفصل بين المعطى الديني بوصفه إيمانا، وبين المعطى التاريخي بوصفه مادة قابلة للفحص والنقد، وهو ما فُهم عند كثيرين على أنه يمس شخصيات دينية مذكورة في القرآن، مثل إبراهيم وإسماعيل، لا من باب الإنكار العقدي المباشر، بل من باب مساءلة السرد التاريخي المرتبط بهما. هنا كان جوهر الإشكال، أي حدود النقد التاريخي حين يلامس الذاكرة الدينية الجماعية. وهذه مسألة فكرية معقدة تتعلق بعلاقة المنهج التاريخي بالنصوص المؤسسة، وليست مسألة دفاع عن الجاهلية بوصفها عصرا ذهبيا. باتريشيا كرون ودور مكة التجاري أما في ما يخص باتريشيا كرون، فقد ناقشت في كتابها الصادر عام 1987 الصورة الاقتصادية التي رسمت لمكة في بعض الدراسات الكلاسيكية، خاصة تلك التي اعتبرتها مركزا رئيسيا في شبكة تجارة عالمية بين اليمن والشام. اعتمدت كرون على تحليل مسارات التجارة المعروفة في المصادر الكلاسيكية، وخلصت إلى أن الدور التجاري المنسوب إلى مكة قد يكون أقل مما صورته السيرة التقليدية أو بعض المستشرقين السابقين، مثل مونتغمري وات. غير أن أطروحتها لم تُستقبل كحقيقة نهائية، بل واجهت نقدا منهجيا واسعا من حيث قراءة الأدلة، ومن حيث الاستنتاجات الجغرافية. أي أننا أمام فرضية جريئة ضمن حقل بحثي حي، لا أمام نتيجة محسومة. والبحث في نشأة الإسلام اليوم شديد التنوع والتعقيد، ويصعب اختزاله في أطروحة واحدة. حرية النقاش وفي النهاية تبقى حرية التفكير والنقاش شرطا أساسيا لأي تقدم معرفي. ليس من الضروري أن يتحول كل طرح فكري إلى معركة، ولا أن يواجه كل رأي بنبرة هجومية. الاختلاف جزء من طبيعة البحث الإنساني، والإيمان، بحسب النص القرآني نفسه، لا يقوم على الإكراه، بل على الاقتناع. أستاذ محاضر في جامعة جورج تاون (الدوحة – قطر)

ليست مذهبًا ولا هُويّة، بل النَّسيجَ الذي ربطَ الزمنَ والمعرفةَ والمجتمعَ في حضارةِ الإسلام. ليس مصطلحُ “أهلِ السُّنّة والجماعة” بالمصطلحِ البسيطِ الذي يُحدِّدُ مجموعةً من الناس أو طائفةً من الطوائف، كما صار يُقالُ عنه. لا شكَّ أنّه، في نهايةِ الأمر، يصفُ أو يُحدِّدُ هُويّةً دينيةً لمجموعةٍ كبيرةٍ من الناس قد تُطلِقُ على نفسها لفظَ “الأمّة”، ولكن هذا التحديد لا يمكن أن يكونَ كلَّ ما يُقدّمه هذا المصطلح. تقول المؤرِّخة باتريشيا كرون، وهي من أبرزِ الباحثين في تاريخِ الإسلام وعلومِه، وقد تكونُ أعتى النّاقدين للتاريخِ الإسلاميّ المبكّر، إنّ “السُّنّة” هم أعضاءُ الجماعةِ التي توصّلت إلى تسويةٍ أو، على الأقلّ، إلى اتفاقٍ على أن يختلفوا. فالمسألةُ ليست في وحدةِ العقيدةِ والشريعة، بل في قبولِ فكرةِ الخلافِ والاختلاف. العولمةُ الحضارية قد يكونُ هذا هو السببَ وراء تحوّلِ ما أُريدُ تسميتَه أنا بـ”السننيّة” إلى العولمةِ الحضاريةِ للإسلام؛ فالسننيّة هي النَّسقُ الداخليُّ المنظِّمُ للحياةِ الإسلامية، الذي يصلُ بين أبعادِها المختلفة: النصِّ والعبادةِ والعادةِ والمؤسّسةِ والزمن. فهي صوتٌ يُشهِد، وعادةٌ تُكرِّر، ومؤسّسةٌ تُسنِد، وطريقٌ يَجمع، وزمنٌ يُوحِّد؛ نسيجٌ حضاريٌّ تشكّل ببطءٍ واستمرارٍ عبر القرون، من ألفاظٍ وطقوسٍ وأسفارٍ وكُتبٍ وأصوات. هي ليست مذهبًا جديدًا، بل المبدأَ الحضاريَّ الذي تشكّلت حولَه الثقافةُ الإسلاميةُ بعد القرنِ الخامسِ الهجريّ؛ نظامٌ من القيمِ والمعارفِ والممارسات نظّم علاقةَ المسلمين بالوحي والزمن والمجتمع، وجعلهم، على اختلافِ أمصارِهم ومذاهبِهم، يتحرّكون بإيقاعٍ واحد. هذه هي البنيةُ التي يمكنُ تسميتُها “النَّسقَ السُّنّيّ”، أو الهيكلَ التاريخيَّ الذي منحَ الحضارةَ الإسلاميةَ تماسكَها واستمراريتَها. رحلةُ العلم تعملُ السننيّةُ وفقَ منطقٍ مؤسّسيٍّ متكاملٍ يقومُ على إعادةِ إنتاجِ المعرفةِ الدينيةِ وضبطِها عبر آليّاتٍ متكرّرةٍ ومتراكبة. ففي جوهرِ هذا المنطقِ مثلاً، يظهرُ السماعُ بوصفِه الوسيلةَ الأساسيّةَ لانتقالِ النصوصِ وضمانِ صحتِها. فالعلاقةُ بين المعلِّمِ والمتعلِّم لم تكن علاقةَ نقلٍ ميكانيكيٍّ، بل عمليّةَ تحقّقٍ متواصلةٍ تحفظُ للنصِّ سلطانَه من خلالِ السندِ الموثوق. ولذلك يمكنُ النظرُ إلى الإسناد بوصفِه نظامًا علميًّا للثقة قبل أن يكونَ إجراءً شكليًّا؛ إذ مكّنَ المجتمعاتِ الإسلاميةَ من بناءِ ذاكرةٍ معرفيّةٍ مشتركةٍ تتجاوزُ الحدودَ السياسيةَ والجغرافية. وإلى جانبِ السماع، مثّلتِ الرحلةُ في طلبِ العلم أحدَ أعمدةِ هذا النظام؛ فقد أسهمت في تشكيلِ شبكةٍ واسعةٍ من التواصلِ العلميّ بين المراكزِ الإسلامية، بحيث صار تداولُ الأفكار يتمّ داخلَ فضاءٍ واحدٍ تتداخلُ فيه المدارسُ والمذاهب. وهكذا تحوّلت السنِّيّة إلى بُنيةٍ شبكيّةٍ تعتمدُ على تنقّلِ العلماءِ والطلاب، وعلى استمراريةِ التعليمِ والإجازة، بما يضمنُ بقاءَ النَّسقِ المعرفيِّ في حالةٍ من الحيويةِ والتجدّد. أمّا المؤسّساتُ التعليميةُ والدينية، مثل المدارسِ والوقفِ والمكتبات، فقد أدّت دورَها في تحويلِ المعرفةِ إلى ممارسةٍ منظّمةٍ قابلةٍ للتكرار. فالمدرسةُ والوقفُ لم يكونا مجرّدَ أدواتِ تعليمٍ أو تمويل، بل آليّاتٍ لضبطِ الإيقاعِ الحضاريّ العامّ؛ تضمنُ استمرارَ التعليمِ والتدوينِ حتى في فتراتِ الاضطرابِ السياسيّ، وتحافظُ على وحدةِ المعاييرِ العلميةِ واللغويةِ في مختلفِ الأقاليم. في تجاربِ المشرقِ الحديث، لا سيّما في لبنانَ وسوريا والعراق، ظهرتْ تحالفاتٌ غيرُ متوقَّعةٍ التقت جميعُها عند هدفٍ واحد: تجاوزِ السننيّة بوصفِها النسيجَ الحضاريَّ التاريخيَّ الذي يملكُ المجالَ العامّ النسيجُ العجيب ومن خلالِ هذه العناصرِ مجتمعةً: السماعِ، والرحلةِ، والمؤسّسةِ، وغيرها كثير، استطاعتِ السننيّة أن توفّرَ إطارًا مستقرًّا لإدارةِ المعرفةِ الدينيةِ عبر الزمن. فهي ليست عقيدةً جامدةً، بل منظومةً متحرّكةً تُنسّق بين النصِّ والعقلِ والزمن، وتحوّلُ الدينَ من مجموعةِ نصوصٍ إلى حضارةٍ تمتلكُ نظامًا داخليًّا للاتصالِ والاستمرار. سمّيتُ هذا النسيجَ “عجيبًا” لأنّه استطاع أن يوفّق بين مكوّناتٍ متباعدةٍ من دون سلطةٍ مركزيةٍ تُلزمُها، فحوّلَ الخلافَ بين المدارسِ والمذاهبِ إلى آليّةٍ منظّمةٍ لإنتاجِ المعرفة، وجعلَ الاختلافَ جزءًا من بُنيةِ النظامِ لا تهديدًا له. لقد أعادت السننيّة ترتيبَ العلاقةِ بين الوحيِ والعقلِ والواقع بطريقةٍ متوازنةٍ؛ فلا يُقصى النصُّ لصالحِ العقل، ولا يُلغى الاجتهادُ بحجّةِ الحرف، بل يُبنى تفاعلٌ عمليٌّ بين مراتبَ محدّدة. ولم تكنِ السننيّة مجرّدَ منظومةٍ تنظّمُ الخلافَ أو تضبطُ التنوّع، بل الإطارَ الحضاريَّ الأوسع الذي تشكّل فيه العالمُ الإسلاميُّ بعد تراجعِ السلطةِ المركزيةِ للخلافة. فقد مثّلتِ البنيةَ التي أمكنَ من خلالها استمرارُ الحياةِ العلميةِ والدينيةِ والاجتماعيةِ في مختلفِ الأقاليم، من دون حاجةٍ إلى مركزٍ سياسيٍّ واحدٍ أو جهازٍ بيروقراطيٍّ موحّد. النَّسقُ الحضاريّ بهذا المعنى، يمكنُ النظرُ إلى السننيّة بوصفِها النَّسقَ الحضاريَّ الذي استقرّت عليه دارُ الإسلام في عصورِها الوسطى، أي النظامَ الذي نظّمَ التداولَ المعرفيَّ واللغويَّ والدينيَّ داخل فضاءٍ متّصلٍ ومتنوّعٍ في آنٍ واحد. وقد وصفَ مارشال هودجسون، وهو صاحبُ أحدِ أهمّ كتبِ التاريخِ الإسلاميّ، هذه المرحلةَ بـ”غلبةِ النَّسقِ السُّنّيِّ العالميّ”، مشيرًا إلى أنّ هذا النَّسقَ لم يكنْ سلطةً سياسيةً ولا مذهبًا واحدًا، بل شبكةً حضاريةً واسعةً تجاوزتِ الانقساماتِ القوميّةَ والإقليميّة، وجمعتِ العالمَ الإسلاميَّ في منظومةٍ مشتركةٍ من العلمِ واللغةِ والشريعةِ والعادة. لقد مثّلَ هذا التحوّل لحظةً فارقةً في تاريخِ الإسلام؛ إذ تحوّلتِ السننيّةُ إلى النسيجِ العامِّ للحضارةِ الإسلامية، واستطاعت أن تُؤطّرَ نشاطَ العلماءِ والفقهاءِ والمتصوّفةِ والإداريين في مدنٍ متباعدةٍ جغرافيًّا، لكنّها متّصلةٌ من حيثُ اللغةُ والمنهجُ والمرجعية. ومن هنا يمكنُ القولُ إنّ “غلبةَ النَّسقِ السُّنّيِّ العالميّ” لم تكنْ ظاهرةً فكريةً فحسب، بل تأسيسًا لنظامٍ حضاريٍّ استمرَّ قرونًا، ووفّرَ للإسلام بنيتَهُ العالميةَ المستقلّةَ عن السلطةِ السياسية. النسيجُ لا يقومُ على الصوتِ الأعلى، بل على الصوتِ الأبقى. الفكرةُ والدولة قد يقولُ قائلٌ إنّ هذا النجاحَ نتيجةُ سلطةٍ سياسيةٍ تبنّتِ السُّنّةَ وفرضتْها، وأنّه من مصلحةِ هذه السلطةِ أن توحِّدَ المفاهيمَ لتملكَ القوّةَ جميعَها وتضمنَ استمراريتَها. ولكن ماذا نقولُ في محنةِ الإمام أحمد؟ حينَ استقوى الخليفةُ المأمونُ بالقولِ في مسألةِ خلقِ القرآن، فثبتَ رجلٌ واحدٌ أمامَ سلطانٍ لا يُنازَع. لماذا غلبتِ الفكرةُ الدولةَ والسلطةَ والقوّة؟ إنّها ليست فكرةً ولا رجلًا، بل نَسقٌ متكاملٌ ترسّخ في البنيةِ التحتيةِ للحضارةِ الإسلامية، التي لا تقبلُ الانقطاعَ ولا التغييرَ الجذريّ. والمثالُ نفسه يقوّضُ فرضيّةَ السلطةِ ومصالحِها في ترسيخِ هذا النَّسق. ولهذا فشلتِ السلطاتُ كلُّها، قديمًا وحديثًا، في أن تُعيدَ تشكيلَ النسيجِ على هواها: يمكنُها أن تُغيّرَ رأسًا أو تُبدّلَ سياسةً، لكنّها لا تملكُ أن تُعيدَ صوغَ النَّسقِ الحضاريَّ نفسه. الصوتُ الأبقى ولئن كثرتِ الفِرقُ والمذاهب، وقد صُنّفتْ فيها الكُتب، فإنّ واحدةً منها لم تتحوّلْ إلى نسيجٍ جامع. ظلّت ظواهرَ موضعيةً أو لحظاتِ احتجاجٍ لامعة، ثم تنطفئ حين تنقطعُ سلاسلُ التكرارِ التي تُحوّلُ الفكرةَ إلى عادةٍ، والعادةَ إلى مؤسّسة. النسيجُ لا يقومُ على الصوتِ الأعلى، بل على الصوتِ الأبقى. في العقودِ الأخيرة، شهدتِ المنطقةُ تحوّلاتٍ فكريةً وسياسيةً عميقةً سعتْ إلى إعادةِ تعريفِ المجالِ الإسلاميِّ وموقعِه في التاريخ. وبرزتْ في هذا السياقِ محاولاتٌ متكرّرةٌ لتفكيكِ النَّسقِ السُّنّيِّ الذي شكّل، على مدى قرون، الإطارَ الحضاريَّ الأوسعَ للعالمِ الإسلاميّ. لم تتّخذْ هذه المحاولاتُ شكلًا واحدًا، بل تنوّعتْ بين حركاتٍ متطرّفةٍ أرادتْ إعادةَ صياغةِ الإسلامِ بالعنفِ والقطيعةِ مع تراثِه، ومشاريعَ أيديولوجيّةٍ يساريةٍ أو قوميّةٍ أو مذهبيّةٍ حاولتْ أن تحلَّ محلَّهُ بأنساقٍ فكريةٍ
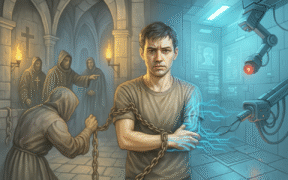
“مَن ينسى التاريخَ محكومٌ عليه أن يعيشه مرةً أخرى”جورج سانتايانا في عام 1492، لم تكن قطرةُ الماء مجرّد عنصرٍ طبيعيّ في البيوت الأندلسيّة، بل صارت شاهدَ إثباتٍ على الحياة أو الموت. هكذا كانت محاكمُ التفتيش الإسبانيّة تُراقب أدقَّ تفاصيلِ الحياةِ اليوميّة، حيث تحوّل استهلاكُ الماء إلى مؤشّرٍ خطيرٍ يحدّد مصيرَ الأسر المسلمة. من يقتصد في استخدامه يُعتبر مسيحيًّا “مُخلِصًا”، ومن يستهلكه بوفرةٍ ـ للوضوء والغُسل ـ يُشتبَه في كونه مسلمًا متخفّيًا، ليواجه مصيرًا مأساويًّا بين اللهب والسيف.لكن السؤال الذي يطرح نفسَه اليوم: هل انتهت هذه الحقبةُ المظلمة فعلاً، أم أنّها تكرّرت بأشكالٍ أكثر تطوّرًا وقسوة؟ وهل تعلّم العالم من دروس التاريخ، أم أنّه محكومٌ عليه بتكرار الأخطاء نفسها؟ محاكمُ التفتيش التكنولوجيّةالإجابة مؤلمةٌ وصادمة: لم تنتهِ محاكمُ التفتيش، بل تطوّرت وتحدثت. في إقليم شينجيانغ الصيني، يعيش أكثر من 12 مليونًا من مسلمي الإيغور كابوسًا حقيقيًّا يفوق في قسوته ما عاشه أسلافُهم في الأندلس. تحت مسمّى برّاق “معسكرات إعادة التأهيل” ـ وهو الاسمُ المهذّب للجحيم ـ يُحتجَز الملايين في مراكز اعتقالٍ مُصمّمة لمحو الهويّة الإسلاميّة بشكلٍ منهجي.لكن الأمر لا يتوقّف عند الاعتقال. في هذه المعسكرات، يُجبَر المسلم على شرب الخمر وتناول لحم الخنزير، ويُعذَّب بوحشيّة إن رفض. تُزرَع في أجسادهم شرائح إلكترونيّة للتتبّع المستمر، وتُراقب كاميرات التعرّف على الوجوه كلَّ حركةٍ في الشوارع والبيوت، بل وحتى في المساجد القليلة المتبقيّة. النساء يتعرّضنَ للاغتصاب المنهجي، والأطفال يُنتزعون من أحضان أمّهاتهم ليُربَّوا بعيدًا عن دينهم وثقافتهم في دورٍ حكوميّة. لم تنتهِ محاكمُ التفتيش، بل تطوّرت وتحدثت. في إقليم شينجيانغ الصيني، يعيش أكثر من 12 مليونًا من مسلمي الإيغور كابوسًا حقيقيًّا يفوق في قسوته ما عاشه أسلافُهم العالم الإسلامي الذي يضمّ 1.8 مليار مسلم يقف متفرّجًا على هذه الإبادة الجماعيّة، تمامًا كما فعل أسلافُه مع مسلمي الأندلس مقارنةٌ صادمة بين الماضي والحاضر | محاكم التفتيش الإسبانيّة (1478-1834) | القمع الصيني للإيغور (2017-اليوم) || مراقبة استهلاك الماء في المنازل | زرع شرائح إلكترونيّة وتتبّع رقمي شامل || التفتيش اليدوي عن المصاحف والكتب | هدم أكثر من 16,000 مسجد وحرق المصاحف || الإجبار على اعتناق المسيحيّة | فرض أيديولوجيّة الحزب الشيوعي بالقوّة || التعذيب الجسدي والحرق | التعذيب المنهجي والاغتصاب الجماعي || فصل العائلات وتهجير الأطفال | انتزاع مليون طفل من عائلاتهم || محاكم دينيّة للإدانة | معسكرات “إعادة تأهيل” للغسيل الدماغي | المصالحُ أهمّ من الإنسانيةهنا تكمن المأساة الحقيقية: العالم الإسلامي الذي يضمّ 1.8 مليار مسلم يقف متفرّجًا على هذه الإبادة الجماعيّة، تمامًا كما فعل أسلافُه مع مسلمي الأندلس قبل خمسة قرون. بل إنّ الأمر أصبح أكثر إثارةً للسخرية والألم، حيث تتسابق الحكومات الإسلاميّة لتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع بكين، بينما تُباد شعوبٌ مسلمة كاملة على بُعد آلاف الكيلومترات.في عام 2019، وقّعت 37 دولة على رسالة تؤيّد سياسات الصين في شينجيانغ، من بينها 16 دولة إسلاميّة تشمل السعوديّة ومصر وباكستان والإمارات. هذا بينما كانت التقارير الدوليّة تكشف عن اعتقال أكثر من مليون إيغوري في معسكرات الاعتقال. إنّها لحظة تاريخيّة مخزية تكشف عن انحطاطٍ أخلاقيّ لم يشهده العالم الإسلامي من قبل.وكما لو أنّ الأمر لا يكفي، تتكرّر المأساة نفسها في غزّة أمام أعيننا، حيث يُقتَل الأطفال والنساء يوميًّا، بينما تكتفي الأنظمة العربيّة والإسلاميّة بالبيانات الاستنكاريّة والمؤتمرات الصحفيّة الفارغة. التاريخ مهزلة إنّ مَن يعتقد أنّ محاكم التفتيش قد أصبحت مجرّد ذكرى من الماضي هو واهمٌ تمامًا. إنّها تتكرّر اليوم بوحشيّة أكبر وأدوات أكثر تطوّرًا وفتكًا: من تكنولوجيا المراقبة والذكاء الاصطناعي إلى المعسكرات المحصّنة والتعقيم القسري. وكما فشل العالم في إنقاذ مسلمي الأندلس، فإنّه اليوم إمّا عاجزٌ أو متواطئ صراحةً في قضيّة الإيغور.لكن المأساة تكتسب بُعدًا هزليًّا مؤلمًا عندما نرى أنّ بعض المسلمين لا يكتفون بالصمت، بل يتعاملون اقتصاديًّا ويتعاطفون سياسيًّا مع جلاديهم، وكأنّ التاريخ لم يكتفِ بتكرار نفسه كمأساة، بل أصرّ على أن يعود كمهزلةٍ سوداء.في الماضي، كان لدى المسلمين عُذر المسافة والجهل بما يحدث. أمّا اليوم، في عصر الإنترنت والأقمار الصناعيّة، فلا عُذر لأحد. كلّ صورة، وكلّ شهادة، وكلّ تقرير متاحٌ بضغطة زر. لكن يبدو أنّ الضمير الجمعي قد مات، وأنّ الكرامة الإنسانيّة صارت سلعةً تُباع وتُشترى في أسواق السياسة والاقتصاد. السؤال الأهم: متى سيستيقظ العالم الإسلامي من غيبوبته؟ ومتى ستعود إليه كرامتُه المفقودة؟ أم أنّنا محكومون بأن نشهد محاكمَ تفتيشٍ جديدةً كلّ بضع قرون، بينما نكتفي بالبكاء على الأطلال؟ الوقتُ ينفد، والتاريخُ لا ينتظر أحدًا.


