
في لبنان، لا شيءَ ينتهي فعلاً، بل يُعاد تدويرُه بأسماءٍ أنيقةٍ ووجوهٍ “نظيفة”.يطلّ علينا نواف سلام اليوم كرجل “الإصلاح” و”الشفافية”، يحمل في جيبه مشروعًا يُشبه بيانًا وزاريًا صاغته السفارة الأميركيّة، ويضع نصب عينيه مهمّة “تاريخيّة”: سحب سلاح حزب الله. أمّا الوعود بالمقابل؟ فسلامٌ سياسيّ شامل، مساعداتٌ ماليّة “محتملة”، وترشيح رمزيّ لجائزة نوبل للسلام، لأنّ العالم يُحبّ دائمًا أن يُكافئ من يُكافئ إسرائيل. منذ الحرب الأهليّة، كان لبنان حقلَ تجاربٍ للتطبيعِ المقنّع.اليوم، المشهدُ نفسُه يُعاد بنسخةٍ أكثر “دبلوماسيّة”: بدل القائد العسكري، لدينا قاضٍ دوليّ يبتسم أمام الكاميرا ويعدنا بـ”عصرٍ جديد بلا سلاح”. الفرق الوحيد أنّ التطبيعَ اليوم يُسوَّق على أنّه “سلامٌ شجاع”، لا “خيانةٌ صريحة”. أميركا تصنع الرموز ولبنان يُصفّق في واشنطن، يبدأ المشروع بجملة: “نريد وجهًا مقبولًا في بيروت”.فيُستخرج أحدُهم من أروقة القضاء الدولي، ويُعطى رتبة “رجل الدولة العاقل”، وتُرسَم له طريقٌ مفروشة بالتصريحات المتزنة. لكن خلف الكواليس، اللعبة أوضح من أن تُخفى: سحب سلاح حزب الله، تفكيك السلاح الفلسطيني في المخيمات، وتهيئة لبنان كمنصّة تطبيعٍ دبلوماسيّ هادئ. وما هو المقابل؟ صورٌ جميلة في نيويورك، تصفيقٌ في مجلس الأمن، وهمُ “الدولة السيّدة” التي لا تملك من السيادة إلّا بيانًا حكوميًا منمّقًا.أمّا الشعب، فله حصّتُه المعتادة من “الوعود الدوليّة”، ودرسٌ جديد في فنّ بيع الوطن بالتقسيط السياسي المريح. من غوتيريش إلى سلامهل يكون نواف سلام المرشّح القادم لخلافة أنطونيو غوتيريش؟ربما. فالغرب يُحبّ الوجوه التي تعرف كيف تتحدّث بلغة “الحقوق الدوليّة” بينما تبتسم للمصالح الأميركيّة.لكن “السلام” الذي يُعَدّ له في بيروت ليس سلامًا بين لبنان وإسرائيل، بل سلامًا بين لبنان ووصايتِه الجديدة.سلامٌ يُنتزع فيه السلاح لا لوقف الحرب، بل لوقف فكرة المقاومة.سلامٌ يُعاد فيه رسم المخيّمات الفلسطينيّة على طريقة “التنظيم المدني”، أي تفكيك آخر جيبٍ يحمل ذاكرة الكفاح.سلامٌ ينتهي بعبارةٍ منمّقة في الأمم المتحدة: “نحن في الشرق الأوسط الجديد”. قد يحصل نواف سلام على جائزة نوبل للسلام، وربما تُعلّق صورتُه في أروقة الأمم المتحدة، لكن لبنان سيبقى بلا كهرباء، بلا عدالة، وبلا كرامة. سيبقى “البلد الذي سلّم سلاحه قبل أن يسلّم فقره”، وصدّق أنّ واشنطن تمنح الجوائز لمن يُحبّ، لا لمن يخضع. والتاريخ، يا دولة الرئيس، لا ينسى مَن سلّم البندقيّة طوعًا ليكسب تصفيقةً عابرةً من عواصم القرار. قد يكتب عنك التاريخ يومًا: “هو الرجل الذي أراد أن يصنع السلام… فخسر البلاد”.
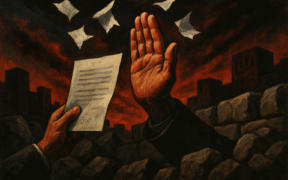
مِن النادرِ أنْ يجدَ رئيسٌ أميركيٌّ نفسَه في مأزقٍ بعدَ إطلاقِ مبادرةٍ كبرى للسلامِ أو وقفِ إطلاقِ النار. غيرَ أنّ الردَّ الفلسطينيَّ الأخيرَ على مقترحِ الرئيسِ دونالد ترامب بشأنِ غزّة كشفَ عن معادلةٍ جديدة: «نعم، ولكن». لم يكنْ هذا الردُّ مجرّدَ صياغةٍ دبلوماسيّةٍ غامضة، بل خطوةٌ محسوبةٌ نقلتِ التحدّي إلى البيتِ الأبيض، وفتحتِ البابَ أمامَ جولةٍ تفاوضيّةٍ أكثرَ تعقيدًا ممّا توقّعها ترامب وإدارته. قبولٌ مشروطٌ لا رفضٌ مباشر أعلنتْ حركةُ حماس قبولَها عناصرَ أساسيّة من الخطة، مثل استعدادِها لمناقشةِ ترتيباتٍ تنفيذيّةٍ انتقاليّةٍ والإفراجِ عن أسرى ضمنَ صيغةٍ تفاوضيّة، لكنّها ربطتْ أيَّ موافقةٍ نهائيّةٍ بجملةٍ من الشروطِ الوطنيّةِ والسياسيّة، وعلى رأسها رفضُ نزعِ السلاحِ القسريّ وضرورةُ التشاورِ مع بقيّةِ الفصائلِ الفلسطينيّة. هذا الموقفُ لا يمكنُ اعتبارُه رفضًا، لكنّه أيضًا ليسَ قبولًا مطلقًا. إنّه خريطةُ طريقٍ لإعادةِ صياغةِ المقترحِ على أُسسٍ جديدة. هيَ مناورةٌ على أكثرَ من جبهة. الاستجابةُ الفلسطينيّة وفّرتْ للحركةِ مساحةً أوسعَ للمناورة: أمامَ المجتمعِ الدوليّ: قدّمتْ صورةَ طرفٍ مسؤولٍ لا يرفضُ التسوياتِ جملةً وتفصيلًا. أمامَ جمهورِها الداخليّ: أكّدتْ أنّها لا تُفرّطُ بالحقوقِ الوطنيّةِ ولا تخضعُ لإملاءاتٍ خارجيّة. أمامَ الوسطاءِ الإقليميّين: أرسلتْ رسالةً واضحةً بأنّها طرفٌ لا يمكنُ تجاوزُه في أيّ عمليّةٍ سياسيّة تخصُّ غزّة أو مستقبلَ القضيّةِ الفلسطينيّة. حرجُ البيت الأبيض الإدارةُ الأميركيّةُ راهنتْ على ردٍّ سريعٍ وحاسم: «نعم أو لا». لكنّ الصيغةَ المشروطةَ أجبرتْ واشنطن على مواجهةِ معضلةٍ؛ فإمّا أنْ تضغطَ من جديدٍ وتُجازفَ بتصعيدٍ عسكريٍّ يُغرقُها في نزاعٍ مفتوح، أو أنْ تقبلَ بالدخولِ في مفاوضاتٍ متعدّدةِ الأطرافِ تفقدُ معها عنصرَ المبادرةِ الذي أرادَ ترامبُ احتكارَه. بكلماتٍ أخرى، الردُّ الفلسطينيُّ عرّى محدوديّةَ القدرةِ الأميركيّةِ على فرضِ تسوياتٍ أحاديّة. والأهمُّ أنّ هذه المناورةَ فتحتِ البابَ أمامَ الفاعلينَ الإقليميّين ـ من مصرَ وقطرَ وتركيا إلى الأممِ المتّحدة ـ كي يعودوا إلى المشهدِ كوسطاء. وهذا يُعيدُ توزيعَ أوراقِ اللعبةِ الدبلوماسيّةِ ويمنعُ واشنطن من الانفرادِ بالقرار. الرسالةُ الأوضح: لا حلَّ دونَ حضورٍ فلسطينيٍّ فعليٍّ على الطاولة، ولا خطةَ قابلةً للحياةِ إذا لم تُراعِ الحدَّ الأدنى من الحقوقِ السياسيّةِ والإنسانيّة. بينَ الذكاءِ والمخاطرة مع ذلك، ليستِ المناورةُ بلا ثمن. فالتعويلُ على «نعم، ولكن» قد ينجحُ في كسبِ الوقتِ وحمايةِ الموقفِ الوطنيّ، لكنّه قد يعرّضُ غزّة لمزيدٍ من الضغوطِ العسكريّة إذا فسّرتْ إسرائيلُ أو الولاياتُ المتّحدةُ الردَّ بأنّه محاولةٌ لكسبِ الوقتِ فقط. النجاحُ في هذا التكتيك سيتوقّفُ على قدرةِ الحركةِ على تحويلِ الشروطِ إلى مسارٍ سياسيٍّ مدعومٍ عربيًّا ودوليًّا، بدلَ أنْ تبقى حبرًا على ورق. ما جرى لم يكنْ مجرّدَ ردٍّ على مبادرةٍ أميركيّة، بل إعادةَ صياغةٍ للمعادلةِ برمّتِها. في لحظةٍ كان يُفترضُ أنْ يُحشَرَ الفلسطينيّون بينَ القبولِ أو الرفض، جاء الجوابُ ليقول: «نعم، ولكن وفقَ شروطِنا». إنّها رسالةٌ بأنّ اللعبةَ لا تُدارُ في البيتِ الأبيضِ وحده، وأنّ إرادةَ الشعوبِ ـ حتّى في أضعفِ الظروف ـ قادرةٌ على إعادةِ توزيعِ موازينِ القوى على الطاولة.

تحيّةُ إكبارٍ إلى الصحافيِّ الفلسطينيِّ حسان مسعود، ابنِ مدينةِ صيدا الذي ولد وترعرع فيها، والذي أُوقف من قِبَلِ بحريّةِ جيشِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لتواجُدِه على متنِ السفينةِ “شيرين” ضمنَ أسطولِ الصمودِ لكسرِ الحصارِ عن غزّة. هذا الشابُّ الطموحُ المفعمُ بالحيويّةِ والعطاء، والذي تدرّجَ في سُلَّمِ “مهنةِ المتاعب” من “إذاعةِ الإسراء” في صيدا إلى كبرياتِ الفضائيّاتِ العالميّة، حاملًا فلسطينَ في قلبِه ووِجدانِه، قرّر ألّا يكتفي بعباراتِ الإدانةِ والاستنكار، ليُقدِمَ على ما يستطيعُ إليه سبيلًا من أجلِ فلسطينَ وجرحِها النازفِ في غزّةَ والضفّةِ وسائرِ بقاعِ الأرض. قد تكون حاملا اليوم للجنسية البرازيلية…لكن صيدا تُحيّيك وتكبرُ فيك… وبأمثالِك. أسطول الصمود العالمي: الاحتلال الإسرائيلي اعترض سفن القافلة السلمية بالمياه الدولية واختطف مئات المتطوعين. أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة محتجزون بشكل غير قانوني بعد اعتراض إسرائيل للأسطول. المشاركون تعرضوا للهجوم بمدافع المياه ورشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم. اعتراض قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي. نطالب بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين في الأسطول وإطلاق سراحهم فورا.




