
يشهدُ اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النار في غزّة، الذي يستندُ إلى مبادرةٍ أمريكيةٍ، حالةً من الغموضِ والتعقيدِ، في ظلِّ تبايُنِ وجهاتِ النظر بين الأطرافِ المعنيّةِ حول آليّاتِ التنفيذِ ومستقبلِ القطاع، وتزايدِ القلقِ الأمريكي من أنَّ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعملُ على تقويضِ الجهودِ الراميةِ إلى إنهاءِ الصراع وتتجلّى هذه التعقيداتُ في الزياراتِ المكوكيّة التي يقومُ بها كبارُ المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب، في محاولةٍ للحفاظ على مسارِ الاتفاقِ الهشّ والدفعِ نحو تطبيقِ الخطةِ المقترحة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفةُ “نيويورك تايمز” عن مصادرَ أمريكيةٍ وجودَ قلقٍ حقيقي داخل الإدارة الأمريكية من احتمالِ انسحابِ نتنياهو من الاتفاق، مشيرةً إلى أنَّ الاستراتيجيةَ الحاليةَ ترتكزُ على منعهِ من استئنافِ العملياتِ العسكرية واسعةِ النطاق. ورغم أنَّ المرحلةَ الأولى من الخطةِ، المتعلّقة بتبادلِ الأسرى، تسيرُ ببطءٍ وحذرٍ، إلّا أنها لم تكن بمنأى عن الانتهاكاتِ الإسرائيلية، فيما تبرزُ عقباتٌ جديدةٌ تعترضُ الانتقالَ إلى المراحلِ التالية، خاصةً في ظلِّ غيابِ رؤيةٍ موحّدةٍ لـ “اليوم التالي” للحرب؛ ليس فقط بين حماس وإسرائيل، بل أيضاً بين الشركاءِ الدوليين والعرب الذين يُنتظرُ منهم تولّي ملفِّ إعادةِ الإعمار. تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم” مَن يحكم؟ ومَن يمول؟ تلقي صحيفةُ “هآرتس” الضوء على ما تصفُه بـ “تقاعس” واشنطن عن وضعِ تصوّرٍ عمليٍّ لمستقبلِ غزّة، حيث بدأت الإدارةُ الأمريكية الآن فقط في محاولةِ تشكيلِ رؤيةٍ واضحة، وسطَ يقينٍ بأنَّ القطاعَ سيظلُّ بلا أفقٍ سياسي في المدى المنظور. وتضيفُ الصحيفةُ أنَّ الهدفَ الأمريكيَّ الأوحدَ حتى الآن كان محصوراً في إنهاءِ القتالِ وإعادةِ الأسرى الإسرائيليين، مع تأجيلِ مناقشةِ الملفاتِ الشائكةِ الأخرى.وعلى الرغم من تسارعِ المحادثات، فإنها لا تزالُ بعيدةً كلَّ البعد عن بلورةِ خطةِ عملٍ متكاملة تُجيب عن التساؤلاتِ الأساسية:“من سيتولّى الإدارة؟ ومن سيموّل إعادة الإعمار؟ ومن سيؤمّن الأمن؟” وتزيدُ الشروطُ الإسرائيليةُ من تعقيدِ المشهد، حيث نشرت صحيفةُ “معاريف”، نقلاً عن مصدرٍ دبلوماسي، أنَّ إسرائيلَ أبلغت واشنطن بإصرارِها على نزعِ سلاحِ حركةِ حماس كشرطٍ لا غنى عنه لبدءِ أي عمليةِ إعمارٍ في القطاع. كما تشترطُ تل أبيب أن تُنفَّذَ مشاريعُ إعادةِ البناء عبرَ جهاتٍ “غيرِ معاديةٍ” لها. في المقابل، يتمسّكُ الشركاءُ العرب بمواقفِهم. فقد نقلت القناةُ 12 العبرية عن مصادرٍ قولها إنَّ الولاياتِ المتحدة حاولت إقناعَ السعوديةِ والإمارات بالمشاركةِ في إعادةِ إعمارِ غزّة والإشرافِ على إدارتها، لكنّ الدولتين رفضتا العرض ما لم تكن السلطةُ الفلسطينية جزءاً أساسياً من الترتيباتِ المستقبلية.وأكد المصدرُ أنَّه “من دونِ السلطة الفلسطينية، لن تتدخّل السعودية لا بشكلٍ مباشرٍ ولا غير مباشر”. تقسيم غزة في ظلِّ هذه التجاذبات، كشفت صحيفةُ “وول ستريت جورنال” عن خطةٍ بديلةٍ تبحثُها الولاياتُ المتحدةُ مع إسرائيل، تقومُ على تقسيمِ قطاعِ غزّة إلى منطقتين منفصلتين.تقضي الخطةُ، التي يدفع بها جاريد كوشنر، صهرُ الرئيسِ الأمريكي السابق ترامب، بأن تخضعَ المنطقةُ الأولى لسيطرةِ الجيش الإسرائيلي وتستفيدَ من مشاريع الإعمار والدعم الدولي، بينما تبقى المنطقةُ الثانية تحت حكمِ حركةِ حماس معزولةً اقتصاديّاً، حتى “نزعِ سلاحها”. وينسجمُ هذا المخططُ مع دعواتٍ سابقةٍ داخل المؤسسةِ الأمنيةِ الإسرائيلية لتحويلِ أجزاءٍ من غزّة إلى ما يشبه “المنطقة ب” في الضفةِ الغربية؛ أي مناطقَ خاضعةٍ لسيطرةٍ مدنيةٍ فلسطينيةٍ شكلية، ولكن تحت إدارةٍ عسكريّةٍ إسرائيليةٍ كاملة.إلا أنَّ هذه الخطة تصطدمُ بعقباتٍ كبرى: القبول الدولي والعربي تواجهُ الخطةُ معضلةً حقيقيةً في الحصولِ على تأييدٍ عربيٍّ ودوليٍّ لفكرةِ ترسيخِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأكثر من نصفِ مساحةِ القطاع. المخاوف الأمنية الإسرائيلية:بحسب “هآرتس”، يخشى الجيشُ الإسرائيليُّ من الاحتكاكِ المباشر مع السكّان الفلسطينيين، وقد أوصى بعدمِ السماحِ بعودتِهم إلى المناطق الخاضعةِ لسيطرته. كما يعتقدُ الجيشُ أنَّ أيَّ قوةٍ دوليةٍ لن تكونَ قادرةً على تدميرِ شبكةِ الأنفاق المتبقية، مما يشكّلُ تهديداً عملياتياً مستقبلياً. تمويل الإعمار:تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم”. سيناريو إسرائيليٌّ… وانتظارٌ لا ينتهي من جهته، يرى تقريرٌ لمعهدِ دراساتِ الأمنِ القوميِّ الإسرائيلي أن على إسرائيل التعاملَ مع الخطةِ الإطاريةِ بمرونة، مع ضمانِ الحفاظِ على نفوذِها الأمني وحريةِ عملِها العسكري، والسيطرةِ على مسارِ إعادةِ الإعمار.ويقترحُ التقريرُ أن تعملَ إسرائيل على تهيئةِ الظروف لتشكيلِ حكومةِ تكنوقراطٍ وقوةِ استقرارٍ دولية، على أن يقتصرَ عملُها على المناطقِ التي لا وجودَ لحماسَ فيها، معتبراً أن نجاحَ هذا الطرح يعتمدُ على استعدادِ تل أبيب للتواصلِ مع السلطةِ الفلسطينية والمشاركةِ في تهيئةِ الظروفِ لإقامةِ دولةٍ فلسطينية. في نهايةِ المطاف، يسودُ التشاؤمُ أوساطَ المحللين. فالقناةُ 12 العبريةُ تتوقعُ أن يدركَ العالمُ سريعاً أنَّ الحكومةَ الإسرائيليةَ الحالية “متطرفةٌ وغيرُ عقلانية، ولا تسعى إلا للحرب وضمِّ الأراضي وتدميرِ السلطة الفلسطينية”. وهكذا، بينما تتحدثُ واشنطن عن "غزّة الجديدة"، يواصلُ الواقعُ إنتاجَ "غزّة القديمة"، ولكن — كما تصفها "هآرتس" — "مع قدرٍ أقلّ من الأملِ ومزيدٍ من التعب"، في ظلِّ روتينٍ جديدٍ من المساعداتِ الإنسانية التي تُبقي القطاعَ على قيدِ الحياة، ولكن بلا أفقٍ سياسيٍّ أو سيادةٍ حقيقية.

بينما كان العالم غارقًا في صخبه اليومي، بين ضجيج الملاعب وصالات السينما ومنصّات التواصل، كانت في غزّة أيادٍ أخرى تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الصراع.في أحد الأنفاق المحاصَرة، وتحت سماءٍ لا ترى فيها سوى طائرات استطلاعٍ وعدسات عدوٍّ متربّص، أعادت كتائب القسّام، الذراع العسكري لحركة حماس، هندسة قنبلة أمريكيّة الصنع من طراز MK-84 ــ لم تنفجر بعدما أُلقيت على القطاع ــ لتتحوّل إلى سلاح فلسطيني ميداني دقيق دمّر دبابة “ميركافا” وجرافة مصفّحة في عمليّةٍ نوعيّة وصفت بأنّها من أكثر الضربات تأثيرًا منذ اندلاع الحرب قنبلة تعود من الموت ليست القنبلة MK-84 قطعة حديد عاديّة. إنّها من أثقل وأخطر القنابل في الترسانة الأمريكيّة، تُستخدم عادةً لتدمير المطارات والجسور والتحصينات الخرسانيّة. لكنّها في غزّة، تحت الحصار، تحوّلت إلى سلاحٍ من صنعٍ فلسطيني بالمعنى الكامل للكلمة.بعمليّة هندسة عكسيّة نفّذها خبراء المقاومة بإمكانات محدودة، أُعيد توظيف أداة دمارٍ صُنعت لتُبيدهم، لتصبح سلاحًا يردّ به الفلسطيني على من ألقاها.هي مفارقة تختصر المشهد: تحويل القهر إلى قدرة، والركام إلى فكرة، والدمار إلى ابتكار.العمليّة لم تكن مجرّد ضربة تكتيكيّة؛ لقد كانت بيانًا سياسيًّا وعقائديًّا بامتياز. بيانًا يقول إنّ المقاومة في غزّة قادرة على أن تُنتج أدواتها، وأنّ الاعتماد على الخارج ليس شرطًا للتحرّر، بل أحيانًا عائقٌ أمامه. الاستقلال لا يُقاس بعدد الحلفاء منذ سنوات، تُحاصَر حركة حماس بالأسئلة الكبرى:هل هي جزء من محورٍ إقليمي؟ هل تتحرّك بأجندة خارجيّة؟ هل تقاتل بقرارها أم بقرار غيرها؟لكنّ مشاهد القنبلة المُعاد تشغيلها من تحت الركام جاءت كإجابة أبلغ من أيّ تصريح.فالذي يصنع سلاحه من حطام قنابل عدوّه، والذي يبتكر في العراء، ويقاوم بلا مصانع ولا حدود مفتوحة، لا يمكن وصفه إلا بأنّه مقاوم ينتمي إلى الأرض. في الواقع، أثبتت تجربة غزّة أنّ الاستقلال الوطني لا يعني العزلة، بل القدرة على اتخاذ القرار من داخل الذّات الجماعيّة، بعيدًا عن وصايات التمويل أو أجندات العواصم.فكل مقاومة ترتبط بمشروع خارجي تُفرّغ مع الوقت من مضمونها، وتتحوّل من أداة تحرّر إلى أداة نفوذ.أمّا المقاومة التي تستمدّ قوّتها من معاناة شعبها، فهي وحدها التي يمكن أن تُعبّر عن وجعه وكرامته في آنٍ واحد. قدّمت العملية صورة رمزيّة لجيلٍ جديد من المقاومين، جيلٍ وُلد بين القصف، تربّى في المساجد، واشتدّ عوده في ساحات المواجهة لا في صالات اللهو عبقريّة تحت الحصار من الناحية التقنيّة، لا يمكن التقليل من حجم الإنجاز العسكري الذي أظهرته هذه العمليّة. فإعادة هندسة قنبلة أمريكيّة ثقيلة وتحويلها إلى عبوة أرضيّة فعّالة تتطلّب خبرات هندسيّة معقّدة، ودقّة عالية في التعامل مع المتفجّرات، وقدرة على التشغيل الآمن في ظروفٍ ميدانيّة قاسية.لكن خلف التقنيّة هناك ما هو أعمق: عقلٌ مقاوم يؤمن أنّ الحصار لا يُطفئ الذكاء، بل يشحذه. لقد تحوّلت غزّة، رغم قيودها، إلى مختبرٍ مفتوح للإبداع العسكري المحلّي، وميدانٍ حيّ يُنتج فكرًا وتكنولوجيا مقاومة لا تُشبه إلا نفسها. جيل الوعي لا جيل اللهو البيان الإعلامي لكتائب القسّام لم يكتفِ بعرض تفاصيل العمليّة، بل قدّم صورة رمزيّة لجيلٍ جديد من المقاومين — جيلٍ وُلد بين القصف، تربّى في المساجد، واشتدّ عوده في ساحات المواجهة لا في صالات اللهو.جيلٌ يحفظ القرآن قبل أسماء اللاعبين، ويعرف معنى الشهادة قبل أن يحفظ أسماء الممثّلين.قد تبدو اللغة عاطفيّة، لكنّها في عمقها رسالة اجتماعيّة: هذا الجيل لا ينتظر العالم، ولا يراهن على مؤتمرات السلام، بل يصنع توازنه الداخلي بين الإيمان والعلم، بين التقوى والابتكار، بين الروح والميدان. من الميدان إلى الفكرة حين نحاول قراءة الحدث بعيدًا عن الانبهار الإعلامي، نجد أنّنا أمام تحوّلٍ نوعي في فلسفة المقاومة الفلسطينيّة:لم تعد حماس تقاتل لتثبت الوجود فقط، بل لتُعيد صياغة مفهوم المقاومة نفسه — من كونه ردّ فعلٍ على العدوان، إلى فعلٍ وطني مستقل يصنع معادلته الخاصّة.بهذا المعنى، تتحرّر حماس — تدريجيًّا — من صورة “الوكيل الإقليمي”، وتقترب أكثر من مفهوم “المقاومة السياديّة”، التي تُحدّد ميدانها وتختار أدواتها وفق المصلحة الوطنيّة الفلسطينيّة لا سواها. ليست العمليّة الأخيرة مجرّد تدمير دبابة وجرافة، بل إعادة تعريف للمعركة. ففي زمنٍ تتسابق فيه القوى على النفوذ عبر الوكلاء، تبدو تجربة حماس أشبه بإصرارٍ على إثبات أنّ القرار الوطني لا يُمنَح، بل يُصنَع. ومن وسط الركام، خرجت القنبلة التي كانت موجهة لتُبيدهم، لتقول بلسان الحديد والنار: "نحن لا نُستورد معركتنا من الخارج، بل نصنعها من وجعنا." ومن رحم الحصار، تواصل غزّة إنتاج معجزاتها — لا بمعونة الآخرين، بل بإرادةٍ وطنيّة تصنع من الموت حياة، ومن القنبلة فكرة.
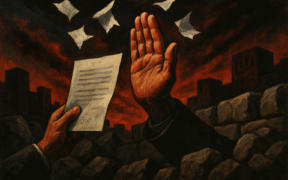
مِن النادرِ أنْ يجدَ رئيسٌ أميركيٌّ نفسَه في مأزقٍ بعدَ إطلاقِ مبادرةٍ كبرى للسلامِ أو وقفِ إطلاقِ النار. غيرَ أنّ الردَّ الفلسطينيَّ الأخيرَ على مقترحِ الرئيسِ دونالد ترامب بشأنِ غزّة كشفَ عن معادلةٍ جديدة: «نعم، ولكن». لم يكنْ هذا الردُّ مجرّدَ صياغةٍ دبلوماسيّةٍ غامضة، بل خطوةٌ محسوبةٌ نقلتِ التحدّي إلى البيتِ الأبيض، وفتحتِ البابَ أمامَ جولةٍ تفاوضيّةٍ أكثرَ تعقيدًا ممّا توقّعها ترامب وإدارته. قبولٌ مشروطٌ لا رفضٌ مباشر أعلنتْ حركةُ حماس قبولَها عناصرَ أساسيّة من الخطة، مثل استعدادِها لمناقشةِ ترتيباتٍ تنفيذيّةٍ انتقاليّةٍ والإفراجِ عن أسرى ضمنَ صيغةٍ تفاوضيّة، لكنّها ربطتْ أيَّ موافقةٍ نهائيّةٍ بجملةٍ من الشروطِ الوطنيّةِ والسياسيّة، وعلى رأسها رفضُ نزعِ السلاحِ القسريّ وضرورةُ التشاورِ مع بقيّةِ الفصائلِ الفلسطينيّة. هذا الموقفُ لا يمكنُ اعتبارُه رفضًا، لكنّه أيضًا ليسَ قبولًا مطلقًا. إنّه خريطةُ طريقٍ لإعادةِ صياغةِ المقترحِ على أُسسٍ جديدة. هيَ مناورةٌ على أكثرَ من جبهة. الاستجابةُ الفلسطينيّة وفّرتْ للحركةِ مساحةً أوسعَ للمناورة: أمامَ المجتمعِ الدوليّ: قدّمتْ صورةَ طرفٍ مسؤولٍ لا يرفضُ التسوياتِ جملةً وتفصيلًا. أمامَ جمهورِها الداخليّ: أكّدتْ أنّها لا تُفرّطُ بالحقوقِ الوطنيّةِ ولا تخضعُ لإملاءاتٍ خارجيّة. أمامَ الوسطاءِ الإقليميّين: أرسلتْ رسالةً واضحةً بأنّها طرفٌ لا يمكنُ تجاوزُه في أيّ عمليّةٍ سياسيّة تخصُّ غزّة أو مستقبلَ القضيّةِ الفلسطينيّة. حرجُ البيت الأبيض الإدارةُ الأميركيّةُ راهنتْ على ردٍّ سريعٍ وحاسم: «نعم أو لا». لكنّ الصيغةَ المشروطةَ أجبرتْ واشنطن على مواجهةِ معضلةٍ؛ فإمّا أنْ تضغطَ من جديدٍ وتُجازفَ بتصعيدٍ عسكريٍّ يُغرقُها في نزاعٍ مفتوح، أو أنْ تقبلَ بالدخولِ في مفاوضاتٍ متعدّدةِ الأطرافِ تفقدُ معها عنصرَ المبادرةِ الذي أرادَ ترامبُ احتكارَه. بكلماتٍ أخرى، الردُّ الفلسطينيُّ عرّى محدوديّةَ القدرةِ الأميركيّةِ على فرضِ تسوياتٍ أحاديّة. والأهمُّ أنّ هذه المناورةَ فتحتِ البابَ أمامَ الفاعلينَ الإقليميّين ـ من مصرَ وقطرَ وتركيا إلى الأممِ المتّحدة ـ كي يعودوا إلى المشهدِ كوسطاء. وهذا يُعيدُ توزيعَ أوراقِ اللعبةِ الدبلوماسيّةِ ويمنعُ واشنطن من الانفرادِ بالقرار. الرسالةُ الأوضح: لا حلَّ دونَ حضورٍ فلسطينيٍّ فعليٍّ على الطاولة، ولا خطةَ قابلةً للحياةِ إذا لم تُراعِ الحدَّ الأدنى من الحقوقِ السياسيّةِ والإنسانيّة. بينَ الذكاءِ والمخاطرة مع ذلك، ليستِ المناورةُ بلا ثمن. فالتعويلُ على «نعم، ولكن» قد ينجحُ في كسبِ الوقتِ وحمايةِ الموقفِ الوطنيّ، لكنّه قد يعرّضُ غزّة لمزيدٍ من الضغوطِ العسكريّة إذا فسّرتْ إسرائيلُ أو الولاياتُ المتّحدةُ الردَّ بأنّه محاولةٌ لكسبِ الوقتِ فقط. النجاحُ في هذا التكتيك سيتوقّفُ على قدرةِ الحركةِ على تحويلِ الشروطِ إلى مسارٍ سياسيٍّ مدعومٍ عربيًّا ودوليًّا، بدلَ أنْ تبقى حبرًا على ورق. ما جرى لم يكنْ مجرّدَ ردٍّ على مبادرةٍ أميركيّة، بل إعادةَ صياغةٍ للمعادلةِ برمّتِها. في لحظةٍ كان يُفترضُ أنْ يُحشَرَ الفلسطينيّون بينَ القبولِ أو الرفض، جاء الجوابُ ليقول: «نعم، ولكن وفقَ شروطِنا». إنّها رسالةٌ بأنّ اللعبةَ لا تُدارُ في البيتِ الأبيضِ وحده، وأنّ إرادةَ الشعوبِ ـ حتّى في أضعفِ الظروف ـ قادرةٌ على إعادةِ توزيعِ موازينِ القوى على الطاولة.




