
قبل أيام، وصلت شاحنة محملة بالردميات لطمرها في الأرض التي تستثمرها بلدية صيدا، إلا أن الموظف المعني رفض إدخالها، بناءً على تعليمات من البلدية تقضي بمنع إدخال أي ردميات من خارج المدينة. يأتي هذا المنع بعد فترة كان يُسمح فيها بذلك مقابل دفع رسوم محددة، مما يثير الشبهات حول وجود جهات تستفيد من الفرق بين الرسوم الفعلية وما كان يدفعه ناقلو الردميات بعد هذا المنع، توجهت الشاحنة إلى معمل معالجة النفايات، حيث استُقبلت وأفرغت حمولتها، وفقاً لمصادر مطلعة، لينقل الردم إلى إحدى التلال المحيطة بالمعمل بعد دفع المبلغ المتفق عليه لإدارة المعمل. ولم تكن هذه الشاحنة الوحيدة، فقد سبقتها شاحنات أخرى أفرغت حمولاتها في أرض ملاصقة للمعمل، كانت إدارته قد حصلت على إذن باستخدامها من بلدية صيدا في وقت سابق؛ فيصدق هنا المثل: “ما لا يدخل من الباب، يدخل من الشباك”. لم يصدر أي رد فعل أو موقف من المجلس البلدي لمدينة صيدا حيال هذه التجاوزات، سوى تململ خجول من عضو هنا أو هناك. واللافت في هذا الإطار أن إدارة المعمل تستقبل نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ومن مناطق مختلفة، على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين البلدية وإدارة المعمل يشترط لاستقبال نفايات من خارج الاتحاد ألّا تتجاوز كمياتها قدرة المعمل على المعالجة، وألّا تؤثر سلباً على الوضع البيئي في المدينة. اليوم، وباعتراف الجميع، فإن المعمل لا يعمل بصورة منتظمة، بل توقف عن العمل لسنوات، حسب اعتراف إدارته. وحتى هذه اللحظة، تكتفي الإدارة بوضع خطط تطويرية وتحسينية دون تنفيذ، وسط غياب تام للمجلس البلدي. يستقبل المعمل نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ومن مناطق مختلفة، على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين البلدية وإدارته يشترط لاستقبال نفايات من خارج الاتحاد ألّا تتجاوز كمياتها قدرته على المعالجة، وألّا تؤثر سلباً على الوضع البيئي في المدينة مضى أكثر من أربعة أشهر على انتخاب المجلس البلدي الجديد، لكنه لم يجتمع لمناقشة مشكلة معمل المعالجة الذي لا يقوم بالمهام المنوطة به، على الرغم من استيفائه رسوماً مقابل معالجة لا تتم. كما تعثر تشكيل لجنة بلدية لمتابعة شؤون المعمل، بعد أن اشترط رئيس البلدية، مصطفى حجازي، أن يرأسها بنفسه وإلا فلا داعي لها، مكتفياً باللجنة الموروثة من المجلس السابق، والتي لم يُعد تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة. وتشهد الفترة الحالية غياباً لهذه اللجنة وأعضائها عن متابعة المعمل وبنود الاتفاق والخطط التطويرية “الفولكلورية”. وللأسف، شُكلت لجنة للبيئة في البلدية، لكنها غير معنية بمتابعة المعمل، وتكتفي بزيارات ونقاشات عامة دون اتخاذ خطوات عملية. كنس ورشوة؟ بدلاً من أن تقوم إدارة المعمل بواجباتها الأساسية، نلاحظ مشاركتها في كنس بعض الشوارع، دون وجود أي اتفاقية مع البلدية. ويُطرح التساؤل عما إذا كانت هذه المبادرة جزءاً من خطة عامة أم “رشوة” لضمان استمرار التوقيع على جداول المعالجة الوهمية، وبالتالي تغطية سياسة نهب المال العام. وتكشف مصادر مطلعة أنه على الرغم من عدم التزام إدارة المعمل بوعودها المتكررة بإصلاحه وإعادة تشغيله بشكل منتظم، فإن السلطة الفعلية المهيمنة على المجلس البلدي تؤجل مناقشة وضع المعمل إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة. ويشير هذا التأجيل إلى وجود حماية سياسية لعملية نهب المال العام، التي تتم من خلال دفع أموال مقابل معالجة لا تحدث، فضلاً عن تحول المعمل إلى مركز لشراء النفايات القابلة للتدوير من “النكيشة” على مرأى ومسمع من بلدية صيدا. فهل سيبادر أعضاء من المجلس البلدي إلى فرض اجتماع لمناقشة خطوات جادة لمعالجة شؤون المعمل؟ أم سيكتفون بالتذمر والانتقادات دون اتخاذ إجراءات عملية تفرض حلاً جدياً وعلمياً لوضع المعمل، يستند إلى السياسات الواجب اتباعها، لا مجرد ملاحظات تقنية يتستر خلفها البعض؟
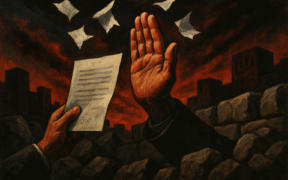
مِن النادرِ أنْ يجدَ رئيسٌ أميركيٌّ نفسَه في مأزقٍ بعدَ إطلاقِ مبادرةٍ كبرى للسلامِ أو وقفِ إطلاقِ النار. غيرَ أنّ الردَّ الفلسطينيَّ الأخيرَ على مقترحِ الرئيسِ دونالد ترامب بشأنِ غزّة كشفَ عن معادلةٍ جديدة: «نعم، ولكن». لم يكنْ هذا الردُّ مجرّدَ صياغةٍ دبلوماسيّةٍ غامضة، بل خطوةٌ محسوبةٌ نقلتِ التحدّي إلى البيتِ الأبيض، وفتحتِ البابَ أمامَ جولةٍ تفاوضيّةٍ أكثرَ تعقيدًا ممّا توقّعها ترامب وإدارته. قبولٌ مشروطٌ لا رفضٌ مباشر أعلنتْ حركةُ حماس قبولَها عناصرَ أساسيّة من الخطة، مثل استعدادِها لمناقشةِ ترتيباتٍ تنفيذيّةٍ انتقاليّةٍ والإفراجِ عن أسرى ضمنَ صيغةٍ تفاوضيّة، لكنّها ربطتْ أيَّ موافقةٍ نهائيّةٍ بجملةٍ من الشروطِ الوطنيّةِ والسياسيّة، وعلى رأسها رفضُ نزعِ السلاحِ القسريّ وضرورةُ التشاورِ مع بقيّةِ الفصائلِ الفلسطينيّة. هذا الموقفُ لا يمكنُ اعتبارُه رفضًا، لكنّه أيضًا ليسَ قبولًا مطلقًا. إنّه خريطةُ طريقٍ لإعادةِ صياغةِ المقترحِ على أُسسٍ جديدة. هيَ مناورةٌ على أكثرَ من جبهة. الاستجابةُ الفلسطينيّة وفّرتْ للحركةِ مساحةً أوسعَ للمناورة: أمامَ المجتمعِ الدوليّ: قدّمتْ صورةَ طرفٍ مسؤولٍ لا يرفضُ التسوياتِ جملةً وتفصيلًا. أمامَ جمهورِها الداخليّ: أكّدتْ أنّها لا تُفرّطُ بالحقوقِ الوطنيّةِ ولا تخضعُ لإملاءاتٍ خارجيّة. أمامَ الوسطاءِ الإقليميّين: أرسلتْ رسالةً واضحةً بأنّها طرفٌ لا يمكنُ تجاوزُه في أيّ عمليّةٍ سياسيّة تخصُّ غزّة أو مستقبلَ القضيّةِ الفلسطينيّة. حرجُ البيت الأبيض الإدارةُ الأميركيّةُ راهنتْ على ردٍّ سريعٍ وحاسم: «نعم أو لا». لكنّ الصيغةَ المشروطةَ أجبرتْ واشنطن على مواجهةِ معضلةٍ؛ فإمّا أنْ تضغطَ من جديدٍ وتُجازفَ بتصعيدٍ عسكريٍّ يُغرقُها في نزاعٍ مفتوح، أو أنْ تقبلَ بالدخولِ في مفاوضاتٍ متعدّدةِ الأطرافِ تفقدُ معها عنصرَ المبادرةِ الذي أرادَ ترامبُ احتكارَه. بكلماتٍ أخرى، الردُّ الفلسطينيُّ عرّى محدوديّةَ القدرةِ الأميركيّةِ على فرضِ تسوياتٍ أحاديّة. والأهمُّ أنّ هذه المناورةَ فتحتِ البابَ أمامَ الفاعلينَ الإقليميّين ـ من مصرَ وقطرَ وتركيا إلى الأممِ المتّحدة ـ كي يعودوا إلى المشهدِ كوسطاء. وهذا يُعيدُ توزيعَ أوراقِ اللعبةِ الدبلوماسيّةِ ويمنعُ واشنطن من الانفرادِ بالقرار. الرسالةُ الأوضح: لا حلَّ دونَ حضورٍ فلسطينيٍّ فعليٍّ على الطاولة، ولا خطةَ قابلةً للحياةِ إذا لم تُراعِ الحدَّ الأدنى من الحقوقِ السياسيّةِ والإنسانيّة. بينَ الذكاءِ والمخاطرة مع ذلك، ليستِ المناورةُ بلا ثمن. فالتعويلُ على «نعم، ولكن» قد ينجحُ في كسبِ الوقتِ وحمايةِ الموقفِ الوطنيّ، لكنّه قد يعرّضُ غزّة لمزيدٍ من الضغوطِ العسكريّة إذا فسّرتْ إسرائيلُ أو الولاياتُ المتّحدةُ الردَّ بأنّه محاولةٌ لكسبِ الوقتِ فقط. النجاحُ في هذا التكتيك سيتوقّفُ على قدرةِ الحركةِ على تحويلِ الشروطِ إلى مسارٍ سياسيٍّ مدعومٍ عربيًّا ودوليًّا، بدلَ أنْ تبقى حبرًا على ورق. ما جرى لم يكنْ مجرّدَ ردٍّ على مبادرةٍ أميركيّة، بل إعادةَ صياغةٍ للمعادلةِ برمّتِها. في لحظةٍ كان يُفترضُ أنْ يُحشَرَ الفلسطينيّون بينَ القبولِ أو الرفض، جاء الجوابُ ليقول: «نعم، ولكن وفقَ شروطِنا». إنّها رسالةٌ بأنّ اللعبةَ لا تُدارُ في البيتِ الأبيضِ وحده، وأنّ إرادةَ الشعوبِ ـ حتّى في أضعفِ الظروف ـ قادرةٌ على إعادةِ توزيعِ موازينِ القوى على الطاولة.

مكالمة واحدة كفيلة بإشعال بلد.صوت مألوف، جملة حاسمة، أمر عاجل… لكن المتحدث ليس وزيرًا ولا قائدًا. إنه الذكاء الاصطناعي، ينسخ الصوت لحظة بلحظة، يخدعك ويقودك حيث يريد. ما كان خيالًا علميًا صار سلاحًا سياسيًا. لم تعد الفتنة تحتاج إلى عميل على الأرض، بل إلى “صوت رقمي” يتقن لهجة الزعيم. في لبنان، حيث الشرارة تكفي، قد تتحول مكالمة وهمية إلى فتنة حقيقية. تخيّل أن يرنّ هاتف أحد الوزراء في بيروت عند منتصف الليل. الرقم الظاهر على الشاشة رسميّ، والصوت على الطرف الآخر مألوف، يحمل نبرة الثقة والسلطة:“نحتاج إلى اتخاذ خطوة عاجلة الليلة… لا تتصل بأحد قبل تنفيذها.” هذا المشهد لم يعد من أفلام الخيال العلمي، بل واقعٌ جديد كشفت عنه تجارب شركة NCC Group البريطانية، المتخصّصة بالأمن السيبراني، بعد نجاحها في تنفيذ هجمات تصيّد صوتي (Vishing) باستخدام تقنيات استنساخ صوتي فوري.ببضع ثوانٍ من التسجيل، أصبح بالإمكان أن يتكلّم أيّ شخص بصوت أيّ شخص آخر، في الزمن الحقيقي، عبر الهاتف أو تطبيقات الاجتماعات مثل Microsoft Teams وGoogle Meet. من التسجيل المزيّف إلى المحادثة الحيّة ما يميّز الجيل الجديد من هذه الهجمات أنّها لم تعد تعتمد على تسجيلات مُعدّة مسبقًا.بل أصبح المهاجم قادرًا على محاكاة الصوت لحظةً بلحظة، والتفاعل مع الضحية في محادثة طبيعية: يجيب، يضحك، يغيّر نبرته، ويقنعك بأنك تتحدّث مع الشخص الحقيقي. والنتيجة؟ انمحاء الحدّ الفاصل بين الواقع والتمثيل.فما كان يُعرف بـ”الخداع الإلكتروني” أصبح اليوم خداعًا سمعيًا إدراكيًا، يضرب مباشرةً في عمق الثقة البشرية، ويجعل من كلّ اتصال هاتفي احتمالًا للاختراق. في بلدٍ لم يتعافَ بعد من أزماته السياسية والاقتصادية، فإنّ زعزعة الثقة بين المكوّنات ليست سوى لعبة خوارزمية سهلة التنفيذ لسان الدولة في بيئات سياسية حساسة مثل لبنان، حيث تتشابك الولاءات وتتداخل الخطوط الحمراء، تكفي مكالمة واحدة مزيفة لتُشعل فتنة.يكفي أن يتلقى ضابط أمني أو مسؤول حزبي اتصالًا “من جهة عليا” تطلب تحركًا ميدانيًا أو توجيهًا إعلاميًا، حتى تتبدّل الموازين في لحظة. وفي بلدٍ لم يتعافَ بعد من أزماته السياسية والاقتصادية، فإنّ زعزعة الثقة بين المكوّنات ليست سوى لعبة خوارزمية سهلة التنفيذ.لم تعد الفتنة تحتاج إلى عميل على الأرض؛ يكفي “صوت رقمي” بلهجة الزعيم ليُحرّك شارعًا بأكمله. وهنا يصبح السؤال الأكبر: كيف يمكن لدولة هشّة أن تواجه هجومًا غير مرئي يبدأ من مكالمة لم يُجرِها أحد؟ من الاحتيال إلى الحرب النفسية في السابق، كان الاحتيال الصوتي يهدف إلى سرقة الأموال أو المعلومات الشخصية.اليوم، تحوّل إلى أداة لتقويض الثقة، والتأثير في الرأي العام، وتوجيه المسارات السياسية. التقنيات التي طُوِّرت لأغراض ترفيهية أو تعليمية، تُستخدم اليوم في عمليات تضليل استراتيجية تموّلها جهات استخباراتية أو شبكات ضغط رقمية.وقد حذّرت تقارير دولية من أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي سيجعل الأصوات المزيّفة أكثر واقعية من الأصل بحلول عام 2026. وحين يُدمج الصوت بالصورة عبر تقنيات “الفيديو العميق” (Deepfake)، سيواجه العالم جيلًا جديدًا من الحروب المعلوماتية، حيث يصبح الكذب أكثر إقناعًا من الحقيقة نفسها. أزمة الثقة التحدّي لم يعد أمنيًا فقط، بل أخلاقيًا ومؤسساتيًا أيضًا.كيف يمكن للحكومات والإعلام التحقق من هوية المتحدّث في زمنٍ يمكن فيه لأي خوارزمية أن تقلّد أي صوت؟هل تكفي بروتوكولات المصادقة الرقمية؟ أم نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد لإثبات الهوية السمعية والبصرية؟ الواقع أنّ العالم لم يضع بعد قواعد اللعبة الجديدة: القوانين متأخرة، الوعي العام ضعيف، والمؤسسات الإعلامية نفسها قد تقع ضحية لمكالمات مصنوعة ببراعة رقمية.وهكذا يتحوّل الذكاء الاصطناعي من حليفٍ للشفافية إلى أداةٍ لتفكيكها. لبنان كنموذج هشّ لبنان، بتاريخ أزماته وتشابك قواه الداخلية والخارجية، يشكّل بيئة نموذجية لاختبار هذا النوع من الهجمات. بلد يعيش على إيقاع الإشاعة السياسية والاحتقان الطائفي، قد يهتزّ بمكالمة واحدة “موثوقة المظهر” تُنسب إلى جهة رسمية أو قيادة حزبية. إنها ليست مجرد مشكلة تقنية، بل قضية أمن وطني. فكل تسجيل مزيف أو اتصال مزور قادر على إعادة رسم المشهد السياسي أو تفجير أزمة في لحظة. هنا، لا يحتاج العدو إلى صاروخ… بل إلى مكالمة هاتفية دقيقة التصميم. في النهاية، نحن أمام سؤال وجودي جديد: إذا كان الصوت والصورة لم يعودا دليلًا على الحقيقة، فما الذي يبقى من الثقة؟ قد لا تكون المعركة المقبلة بين جيوشٍ أو أنظمة، بل بين العقل البشري وغريزته في التصديق. إنّ ما يحدث ليس مجرد تطوّر تقني، بل ثورة في صناعة الإدراك. وإذا لم تُسرع الحكومات والإعلام والمجتمعات إلى وضع ضوابط واضحة، سنستيقظ ذات يوم على أزمة كبرى بدأت — لا من قرار سياسي، بل من اتصال هاتفي لم يُجرِه أحد. ربما حان الوقت لأن تُدرج الدول بندًا جديدًا في استراتيجياتها الأمنية: "تحقق من الصوت… قبل أن تردّ." ففي عالمٍ باتت فيه الخوارزميات تتحدث بلهجات البشر وتخترق مؤسساتهم، لن تكون المعركة المقبلة على الأرض… بل في الأذن.




