
لم تكن نارُ غزّة لتهدأ، لو لم تَعُد مصر، من خلال قمة شرم الشيخ للسلام 2025، التي انعقدت برئاسةِ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتؤكِّد ما يحاول البعضُ نسيانَه أو تجاهلَه: أن لا تسويةَ حقيقية في المشرق، وأن لا تهدئةَ ممكنة على حدود فلسطين المحتلّة، دون المرور عبر القاهرة لم يكن في هذه العودة، التي تلاقي إعلان نيويورك الذي قادته المملكة العربية السعودية وفرنسا، أيُّ صدفة، بل استعادةٌ لدورٍ أصيلٍ تحكمه الجغرافيا، ويثبِّته التاريخ، وتديره مؤسّساتٌ تعرف متى تَصمت، ومتى تتحرّك، ومتى تتكامل مع أشقائها العرب. الدبلوماسيةُ الهادئةُ والقوةُ الصامتةُ منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزّة، انتهجت مصر مساراً هادئاً، بعيداً عن الصخب الإعلامي الذي يُرافق تحرّكات بعض القوى الإقليمية. عملت وزارةُ الخارجية المصرية وأجهزتُها الأمنية عبر قنواتٍ مزدوجة ـ علنيةٍ وسرّية ـ لتأمين ممرّاتٍ إنسانية، وضمان تدفّق المساعدات، ودفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار. لكنّ الأهم أن مصر أعادت تفعيل آليّتِها التقليدية في الوساطة: الجمع بين الحوار الأمني الميداني والضغط السياسي المتدرّج. فبينما انشغلت العواصم الغربية بلغة البيانات، كانت القاهرة تجلس مع وفودٍ من “حماس” ومن إسرائيل، تستمع وتضغط، وتعيد صياغة الشروط بطريقةٍ تحفظ لكل طرفٍ ما يمكن تسويقه لجمهوره. وما لم يُعلَن كثيراً، هو أن مصر لم تكتفِ بالدبلوماسية. ففي الأسابيع الأخيرة، لوحظت تحرّكات عسكرية مصرية منسَّقة في المنطقة المنزوعة السلاح في شمال سيناء، ضمن الحدود التي رسمها اتفاق السلام مع إسرائيل. هذه التحرّكات لم تكن استفزازاً، بل رسالةً مضبوطةَ الإيقاع: أن مصر قادرة على فرض الأمن في نطاقها الحيوي، وأن استقرار سيناء خطٌّ أحمر، وأنها الضامن الموثوق لأي ترتيباتٍ ما بعد الحرب، سواء في غزّة أو على المعابر. فالدور المصري ليس خياراً تكتيكياً في أزمة غزّة، بل ضرورةٌ بنيويةٌ لحفظ توازن الإقليم، وضمان أن الحرب مهما اشتعلت ستنتهي على طاولةٍ تعرف القاهرة كيف تُديرها فعندما تتعقّد الملفات وتختنق القنوات، تعود القاهرة لتضع بصمتها، فتتحرّك الأبواب المغلقة. غيابٌ مقصودٌ وعودةٌ مقرّرةٌ تبدو مصر أحياناً كأنها تنسحب من المسرح الإقليمي، منشغلةً بأولوياتها الداخلية أو متريّثةً أمام زخم القوى الجديدة في المنطقة. لكنّ هذا الغياب غالباً ما يكون استراتيجياً لا عجزاً. فعندما تتعقّد الملفات وتختنق القنوات، تعود القاهرة لتضع بصمتها، فتتحرّك الأبواب المغلقة. إنها سياسة “الصمت الفعّال” التي تميّز المدرسة المصرية في إدارة الأزمات: ترك الآخرين يتقدّمون ويستهلكون أوراقهم، ثم الدخول في اللحظة المناسبة، بالثقل المؤسّسي والأمني الذي لا يملكه أحدٌ سواها. وفي كل مرّة، يتذكّر الجميع أن مصر ليست مجرّد “جارٍ لغزّة”، بل الركيزةُ الأمنية والسياسية للمنطقة بأكملها. وراء هذه الحركة المتقنة تقف المؤسّسة الأمنية المصرية ـ من الجيش إلى المخابرات العامة ـ التي تُدير المشهد بعقلٍ باردٍ وتوازنٍ دقيقٍ بين الأمن والسياسة. هذه المؤسّسة، التي خرجت من حروبٍ وصراعاتٍ طويلة، تعرف طبيعة الخصوم، وتفهم حدود الردع والاحتواء. وبينما يتغيّر الخطاب السياسي في الإقليم، تبقى المؤسّسة المصرية ثابتةً في رؤيتها: لا أمنَ في غزّة دون دورٍ مصري، ولا استقرارَ في إسرائيل دون تنسيقٍ مصري، ولا مستقبلَ للفلسطينيين دون غطاءٍ مصريٍّ عربيٍّ شرعي. تُثبت التجربة مجدّداً أن مصر قد تغيب، لكنها لا تُغاب. حين تسكت، تُحسب خطواتُها، وحين تعود، تعود بثقلها التاريخي وموقعها الجيوسياسي الممتدّ بين المتوسّط والبحر الأحمر، وبين العالم العربي وإفريقيا. فالدور المصري ليس خياراً تكتيكياً في أزمة غزّة، بل ضرورةٌ بنيويةٌ لحفظ توازن الإقليم، وضمان أن الحرب ـ مهما اشتعلت ـ ستنتهي على طاولةٍ تعرف القاهرة كيف تُديرها. من إعلان نيويورك إلى قمة شرم الشيخ للسلام، تحرّكت جمهوريةُ مصر العربية اليوم، كما المملكة العربية السعودية، على إيقاعٍ يعرفه كلُّ من خبرهما: إيقاعُ الدول التي لا تحتاج إلى إعلان نياتها لتُدرَك نتائجُها. * الأمين العام ل"تيّار المستقبل"

بعد عامين من الحربِ المفتوحةِ والعدوانِ المُجرَمِ على قطاعِ غزّة، لم يَعُدِ السؤال: مَن الذي أطلقَ النارَ أوّلًا، بل مَن الذي بقيَ واقفًا في النهاية.فالحربُ التي وعدتْ فيها إسرائيلُ شعبَها بـ«القضاءِ على حماس» تحوّلتْ إلى مأزقٍ تاريخيٍّ يُهدّد كيانَها من الداخل، ويُقلِبُ معادلاتِ القوّةِ التي أرستْها لعقود منذ اليوم الأوّل، بدتِ العمليةُ أكبرَ من مجرّدِ معركةٍ عسكريّة؛ كانت محاولةً لإعادةِ صياغةِ الشرقِ الأوسط عبرَ كسرِ إرادةِ غزّة، لكنها انتهتْ بانكسارِ المشروعِ الإسرائيليِّ نفسِه أمامَ صلابةِ خصمِه. الميدانِ وسقوطٌ المعنويّات على مدى عامين، استنزفتِ الحربُ جيشَ الاحتلالِ في معاركِ المدنِ والأنفاق، فانهارتْ أسطورةُ “الجيشِ الذي لا يُقهَر” على أبوابِ غزّة.لم يَعُد التفوّقُ التكنولوجيُّ قادرًا على حَسمِ المواجهة، إذ واجهَ الجنودُ مقاومةً مرِنةً، تتحرّك من تحتِ الأرضِ وتضرِبُ في كلِّ اتجاه.الآلافُ من القتلى والجرحى والمُعاقين تركوا ندبةً عميقةً في الوعي الإسرائيلي، ومعَهم تلاشتْ الثقةُ بين المؤسّسةِ العسكريّةِ والجمهورِ الذي اكتشفَ أنَّ الحربَ لم تحمِه، بل زادتْ من خوفِه.المجتمعُ الإسرائيليُّ اليومَ أكثرُ انقسامًا من أيِّ وقتٍ مضى، تتنازعُه الصراعاتُ السياسيّةُ والدينيّة، ويعيشُ حالةَ قلقٍ جماعيٍّ حولَ معنى “الأمن” في دولةٍ لم تَعُد قادرةً على حمايةِ نفسِها من الداخل. انهيارٌ اقتصاديٌّ وسياسيّ اقتصاديًّا، دفعتْ إسرائيلُ ثمنًا باهظًا تجاوز 150 مليار دولار خلال عامين، وسطَ تراجعِ الاستثمارِ وهروبِ الشركاتِ وتقلّصِ احتياطيِّ النقد.ترافقَ ذلك مع تصاعدِ الهجرةِ المعاكسةِ لليهود، وتراجعٍ حادٍّ في معدّلاتِ الهجرةِ الوافدة، في مؤشِّرٍ واضحٍ على اهتزازِ الإيمانِ بمستقبلِ “الدولةِ الآمنة”.أمّا سياسيًّا، فقد تحوّلتِ الحربُ إلى عبءٍ ثقيلٍ على القيادةِ الإسرائيليّةِ التي تُواجهُ أزمةَ شرعيّةٍ غيرَ مسبوقة، وتراجعًا في ثقةِ الشارعِ بالحكومةِ والجيشِ معًا.تفكّكتِ الجبهةُ الداخليّة، وتحوّل الخطابُ من “الانتصارِ الحتميِّ” إلى “إدارةِ الخسائر”، فيما تآكلتْ صورةُ إسرائيلَ كقوّةٍ مستقرّةٍ تقودُ المنطقة. لم تُحدِّدِ الحربُ حدودًا جديدةً للأرض، بل حدودًا جديدةً للوعي: أنَّ القوّةَ بلا قضيّة تنهزم، وأنَّ الوطنَ حينَ يؤمنُ بنفسِه، لا يُهزَمُ أبدًا انكشافٌ دبلوماسيٌّ وعزلةٌ دوليّة لم تكتفِ الحربُ بإشعالِ الميدان، بل أشعلتْ غضبَ العالم.انهارتْ صورةُ إسرائيلَ في الرأيِ العامِّ الغربيّ، وامتلأتِ العواصمُ الأوروبيّةُ بالمظاهراتِ المُندِّدةِ بالدمارِ في غزّة.تراجعتْ علاقاتُها مع دولٍ كانت تُعَدّ ركائزَ في مشروعِ التطبيعِ الإقليميّ، وتعطّلتْ اتفاقاتٌ كانت تُسوَّقُ كـ”سلامٍ اقتصاديٍّ جديد”.حتى في الولاياتِ المتحدة، الحليفِ الأوثق، باتتْ إسرائيلُ تُواجهُ انتقاداتٍ علنيّةً من داخلِ الكونغرس والجامعاتِ والشارعِ الأميركيّ.لقد خسرتْ إسرائيلُ أكثرَ من دعمِ العالم، خسرتْ قدرتَها على تبريرِ أفعالِها. فشلُ تصفيةِ القضيّةِ الفلسطينيّة كانتِ الحربُ بالنسبةِ لإسرائيلَ فرصةً ذهبيّةً لتصفيةِ القضيّةِ الفلسطينيّةِ تحتَ غطاءِ “الأمنِ القوميّ”، لكنَّ النتيجةَ جاءتْ معاكسةً تمامًا.عاد الصوتُ الفلسطينيُّ إلى واجهةِ العالم، وتحوّلتْ غزّةُ من منطقةٍ محاصَرةٍ إلى رمزٍ عالميٍّ للمقاومةِ والصمود.المنابرُ الدوليّة، والمنظّماتُ الإنسانيّة، وحتى الرأيُ العامُّ الغربيّ، وجّهوا البوصلةَ مُجدّدًا نحو أصلِ الصراع: الاحتلال.بهذا المعنى، لم تفشلْ إسرائيلُ في القضاءِ على حركة، بل فشلتْ في طَمسِ قضيّة. وعلى الرغمِ من الدمارِ الهائلِ والمعاناة، خرجتْ حماسُ من الحربِ بعد عامين وهي ما زالت واقفةً، تُديرُ الميدانَ وتفرضُ معادلةً جديدةً للردع.لم يكن انتصارُها عسكريًّا تقليديًّا، بل سياسيًّا ومعنويًّا، إذ استطاعتْ أن تُبقي جذوةَ المقاومةِ حيّةً، وتمنعَ إسرائيلَ من إعلانِ أيِّ نصرٍ واضح.حماسُ لم تربحِ الحربَ بالمعنى الكلاسيكيّ، لكنها انتصرتْ بمعنى الاستمرار، وهذا وحدَه كافٍ لتغييرِ ميزانِ الردعِ في المنطقة. هزيمةُ المشروعِ لا المعركة الخسارةُ الإسرائيليّةُ لم تكن فقط في الميدان، بل في جوهرِ مشروعِها القائمِ على الردعِ والتفوّقِ والسيطرة.فقدتْ إسرائيلُ هيبتَها، وتصدّعتْ صورتُها كقوّةٍ قادرةٍ على فرضِ واقعٍ جديد، وأصبحتْ مثالًا حيًّا على أنَّ التكنولوجيا لا تحسمُ معركةً حينَ تفتقدُ الرؤية.الحربُ التي استمرّتْ عامين أنهكتْ جيشًا بأكمله، وعرّتْ بنيةً سياسيّةً متآكلة، وطرحتْ على المجتمعِ الإسرائيليِّ سؤالًا وجوديًّا غيرَ مسبوق:هل ما زالتْ هذه الدولةُ قادرةً على البقاءِ وسطَ بحرٍ من المقاومة؟ بعد عامين من النار، لم تنتصرْ إسرائيلُ رغمَ تفوّقِها، ولم تُهزَمْ غزّةُ رغمَ جراحِها. النتيجةُ الأوضح أنَّ الردعَ الإسرائيليَّ سقط، وأنَّ الوعيَ الفلسطينيَّ انتصر. رَبِحتْ غزّةُ المعنى والكرامةَ والحقَّ في البقاء، فيما خسرتْ إسرائيلُ روايتَها وهيبتَها، وربّما آخرَ أوراقِها في معركةِ الصورةِ أمامَ العالم. وهكذا، لم تُحدِّدِ الحربُ حدودًا جديدةً للأرض، بل حدودًا جديدةً للوعي: أنَّ القوّةَ بلا قضيّة تنهزم، وأنَّ الوطنَ حينَ يؤمنُ بنفسِه، لا يُهزَمُ أبدًا.
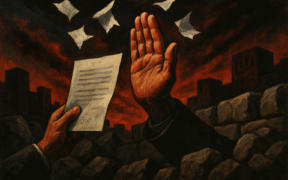
مِن النادرِ أنْ يجدَ رئيسٌ أميركيٌّ نفسَه في مأزقٍ بعدَ إطلاقِ مبادرةٍ كبرى للسلامِ أو وقفِ إطلاقِ النار. غيرَ أنّ الردَّ الفلسطينيَّ الأخيرَ على مقترحِ الرئيسِ دونالد ترامب بشأنِ غزّة كشفَ عن معادلةٍ جديدة: «نعم، ولكن». لم يكنْ هذا الردُّ مجرّدَ صياغةٍ دبلوماسيّةٍ غامضة، بل خطوةٌ محسوبةٌ نقلتِ التحدّي إلى البيتِ الأبيض، وفتحتِ البابَ أمامَ جولةٍ تفاوضيّةٍ أكثرَ تعقيدًا ممّا توقّعها ترامب وإدارته. قبولٌ مشروطٌ لا رفضٌ مباشر أعلنتْ حركةُ حماس قبولَها عناصرَ أساسيّة من الخطة، مثل استعدادِها لمناقشةِ ترتيباتٍ تنفيذيّةٍ انتقاليّةٍ والإفراجِ عن أسرى ضمنَ صيغةٍ تفاوضيّة، لكنّها ربطتْ أيَّ موافقةٍ نهائيّةٍ بجملةٍ من الشروطِ الوطنيّةِ والسياسيّة، وعلى رأسها رفضُ نزعِ السلاحِ القسريّ وضرورةُ التشاورِ مع بقيّةِ الفصائلِ الفلسطينيّة. هذا الموقفُ لا يمكنُ اعتبارُه رفضًا، لكنّه أيضًا ليسَ قبولًا مطلقًا. إنّه خريطةُ طريقٍ لإعادةِ صياغةِ المقترحِ على أُسسٍ جديدة. هيَ مناورةٌ على أكثرَ من جبهة. الاستجابةُ الفلسطينيّة وفّرتْ للحركةِ مساحةً أوسعَ للمناورة: أمامَ المجتمعِ الدوليّ: قدّمتْ صورةَ طرفٍ مسؤولٍ لا يرفضُ التسوياتِ جملةً وتفصيلًا. أمامَ جمهورِها الداخليّ: أكّدتْ أنّها لا تُفرّطُ بالحقوقِ الوطنيّةِ ولا تخضعُ لإملاءاتٍ خارجيّة. أمامَ الوسطاءِ الإقليميّين: أرسلتْ رسالةً واضحةً بأنّها طرفٌ لا يمكنُ تجاوزُه في أيّ عمليّةٍ سياسيّة تخصُّ غزّة أو مستقبلَ القضيّةِ الفلسطينيّة. حرجُ البيت الأبيض الإدارةُ الأميركيّةُ راهنتْ على ردٍّ سريعٍ وحاسم: «نعم أو لا». لكنّ الصيغةَ المشروطةَ أجبرتْ واشنطن على مواجهةِ معضلةٍ؛ فإمّا أنْ تضغطَ من جديدٍ وتُجازفَ بتصعيدٍ عسكريٍّ يُغرقُها في نزاعٍ مفتوح، أو أنْ تقبلَ بالدخولِ في مفاوضاتٍ متعدّدةِ الأطرافِ تفقدُ معها عنصرَ المبادرةِ الذي أرادَ ترامبُ احتكارَه. بكلماتٍ أخرى، الردُّ الفلسطينيُّ عرّى محدوديّةَ القدرةِ الأميركيّةِ على فرضِ تسوياتٍ أحاديّة. والأهمُّ أنّ هذه المناورةَ فتحتِ البابَ أمامَ الفاعلينَ الإقليميّين ـ من مصرَ وقطرَ وتركيا إلى الأممِ المتّحدة ـ كي يعودوا إلى المشهدِ كوسطاء. وهذا يُعيدُ توزيعَ أوراقِ اللعبةِ الدبلوماسيّةِ ويمنعُ واشنطن من الانفرادِ بالقرار. الرسالةُ الأوضح: لا حلَّ دونَ حضورٍ فلسطينيٍّ فعليٍّ على الطاولة، ولا خطةَ قابلةً للحياةِ إذا لم تُراعِ الحدَّ الأدنى من الحقوقِ السياسيّةِ والإنسانيّة. بينَ الذكاءِ والمخاطرة مع ذلك، ليستِ المناورةُ بلا ثمن. فالتعويلُ على «نعم، ولكن» قد ينجحُ في كسبِ الوقتِ وحمايةِ الموقفِ الوطنيّ، لكنّه قد يعرّضُ غزّة لمزيدٍ من الضغوطِ العسكريّة إذا فسّرتْ إسرائيلُ أو الولاياتُ المتّحدةُ الردَّ بأنّه محاولةٌ لكسبِ الوقتِ فقط. النجاحُ في هذا التكتيك سيتوقّفُ على قدرةِ الحركةِ على تحويلِ الشروطِ إلى مسارٍ سياسيٍّ مدعومٍ عربيًّا ودوليًّا، بدلَ أنْ تبقى حبرًا على ورق. ما جرى لم يكنْ مجرّدَ ردٍّ على مبادرةٍ أميركيّة، بل إعادةَ صياغةٍ للمعادلةِ برمّتِها. في لحظةٍ كان يُفترضُ أنْ يُحشَرَ الفلسطينيّون بينَ القبولِ أو الرفض، جاء الجوابُ ليقول: «نعم، ولكن وفقَ شروطِنا». إنّها رسالةٌ بأنّ اللعبةَ لا تُدارُ في البيتِ الأبيضِ وحده، وأنّ إرادةَ الشعوبِ ـ حتّى في أضعفِ الظروف ـ قادرةٌ على إعادةِ توزيعِ موازينِ القوى على الطاولة.




